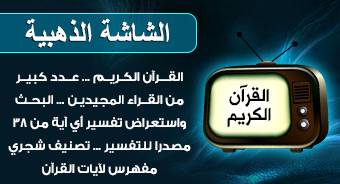.فوائد لغوية وإعرابية:
.فوائد لغوية وإعرابية:
قال السمين:قوله:
{مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ} {ما} موصولةٌ بمعنى الذي، صلتُها
{إنَّ} وما في حَيِّزها، ولهذا كُسِرَتْ. ونَقَل الأخفش الصغير عن الكوفيين مَنْعَ الوَصْلِ ب
{إنَّ} وكان يَسْتَقْبح ذلك عنهم. يعني لوجودِه في القرآن.قوله:
{لَتَنُوءُ بالعصبة} فيه وجهان، أحدُهما: أنَّ الباءَ للتعديةِ كالهمزةِ، ولا قَلْبَ في الكلام. والمعنى: لَتُنِيْءُ المفاتيحُ العُصْبَةَ الأقوياءَ، كما تقولُ: أَجَأْتُه وجِئْتُ به، وأَذْهَبْتُه وذَهَبْتُ به. ومعنى ناء بكذا: نَهَضَ بِهِ بثِقَلٍ. قال:
تَنُوْءُ بأُخْراها فَلأْيًا قِيامُها ** وَتَمْشِي الهوينى عن قَريبٍ فَتَبْهَرُوقال أبو زيد: نُؤْتُ بالعَمَل أي: نَهَضْتُ. قال:
إذا وَجَدْنا خَلَفًا بِئْسَ الخَلَفْ ** عبدًا إذا ما ناء بالحِمْلِ وَقَفْوفَسَّره الزمخشريُّ بالإِثْقال. قال: يُقال: ناء به الحِمْلُ، حتى أَثْقله وأماله وعليه يَنْطبقُ المعنى أي: لَتُثْقِلُ المفاتحُ العُصْبةَ.والثاني: أنَّ في الكلام قَلْبًا، والأصلُ: لَتَنُوْءُ العُصْبةُ بالمفاتحِ، أي: لَتَنْهَضُ بها. قاله أبو عبيد، كقولهم: عَرَضْتُ الناقةَ على الحَوْضِ. وقد تقدم الكلامُ في القَلْبِ، وأنَّ فيه ثلاثةَ مذاهبَ.وقرأ بُدَيْل بن مَيْسَرة
{لَيَنُوْءُ} بالياء مِنْ تحتُ والتذكير؛ لأنه راعى المضافَ المحذوفَ. إذ التقديرُ: حِمْلُها أو ثِقْلُها. وقيل: الضَمير في
{مفاتِحَه} لقارون، فاكتسب المضافُ من المضاف إليه التذكيرَ كقولِهم: ذهبَتْ أهلُ اليمامةِ قاله الزمخشري. يعني كما اكتسبَ أهلُ التأنيثَ اكتسَبَ هذا التذكيرَ.قوله:
{إِذْ قَالَ} فيه أوجهٌ: أَنْ يكونَ معمولًا لتنوءُ. قاله الزمخشري: أو ل بغى قاله ابنُ عطية.ورَدَّهما الشيخُ: بأنَّ المعنى ليس على التقييد بهذا الوقتِ. أو ل
{آتيناه} قاله أبو البقاء. ورَدَّه الشيخ: بأن الإِتياءَ لم يكنْ ذلك الوقتَ، أو لمحذوفٍ فقدَّره أبو البقاء: بَغَى عليهم. وهذا يَنْبغي أَنْ يُرَدَّ بما رُدَّ به قولُ ابنِ عطية. وقَدَّره الطبري: اذكُرْ، وقَدَّره الشيخُ: أظهر الفرحَ وهو مناسِبٌ.وقُرِىء
{الفارِحين} حكاها عيسى الحجازي.قوله:
{فِيمَآ آتَاكَ} يجوزُ أَنْ يتعلَّقَ ب
{ابْتَغٍ} وأَنْ يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنه حالٌ أي: مُتقلِّبًا فيما آتاكَ. و
{ما} مصدريةٌ أو بمعنى الذي.قوله:
{كَمَآ أَحْسَنَ} أي: إحْسانًا كإحسانه إليك.قوله:
{فِي الأرض} يجوز أَنْ يتعلَّقَ ب
{تَبْغِ} أو بالفساد، أو بمحذوفٍ على أنه حالٌ وهو بعيدٌ.قوله:
{على عِلْمٍ} حالٌ مِنْ مرفوع
{أُوتِيْتُه}.قوله:
{عندي} إمَّا ظرفٌ ل
{أُوْتِيْتُه} وإمَّا صفةٌ للعلم.قوله:
{مَنْ هُوَ أَشَدُّ} {مَنْ} موصولةٌ أو نكرةٌ موصوفةٌ. وهو في موضع المفعولِ ب
{أَهْلَكَ}. و
{مِنْ قبلِه} متعلقٌ به. و
{مِنَ القرون} يجوزُ فيه ذلك، ويجوزُ أَنْ يكونَ حالًا مِنْ
{مَنْ هو أشدُّ}.قوله:
{وَلاَ يُسْأَلُ} هذه قراءةُ العامَّةِ على البناء للمفعول، وبالياءِ مِنْ تحتُ ورَفْعِ الفعلِ. وقرأ أبو جعفر
{ولا تُسْأَلْ} بالتاء مِنْ فوقُ والجزم. وابنُ سيرين وأبو العالية كذلك، إلاَّ أنه مبنيٌّ للفاعل وهو المخاطَبُ. قال ابن أبي إسحاق: لا يجوزُ ذلك حتى تنصبَ المجرمين. قال صاحب اللوامح: هذا هو الظاهرُ؛ إلاَّ أنه لَمْ يَبْلُغْني فيه شيء. فإنْ تَرَكاه مرفوعًا فيحتمل وجهين، أحدهما: أَنْ يكونَ
{المجرمون} خبرَ مبتدأ محذوفٍ، أي: هم المجرمون. والثاني: أَنْ يكونَ بدلًا مِنْ أصلِ الهاءِ والميم في
{ذُنوبهم} لأنهما مرفوعا المحلِّ يعني أنَّ ذنوبًا مصدرٌ مضافٌ لفاعلِه. قال: فحمل المجرمون على الأصلِ، كما تقدَّم لنا في قراءة:
{مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٍ} [البقرة: 26] بجرِّ بعوضة. وكان قد خَرَّجها على أن الأصلَ: بضَرْب مَثَلِ بعوضةٍ وهذا تعسُّفٌ كثيرٌ. ولا ينبغي أَنْ يَقْرأ ابنُ سيرين وأبو العالية
{إلاَّ المجرمين} بالياءِ فقط، وإنما تُرِك نَقْلُها لظهورِه. اهـ.
 .من لطائف وفوائد المفسرين:
.من لطائف وفوائد المفسرين:
من لطائف القشيري في الآية:قال عليه الرحمة: قوله جلّ ذكره:
{إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ}.جاء في القصص أنه كان ابن عمِّ موسى، وكان من أعبد بني إسرائيل، وكان قد اعتزل الناسَ، وانفرد في صومعته يتعبَّد، فتصوَّر له إبليسُ في صورة بَشَرٍ، وأخذ في الظاهر يتعبَّدُ معه في صومعته حتى تعجَّب قارونُ من كثرة عبادته، فقال له يومًا: لسنا في شيء؛ عيونُنا على أيدي الناسِ حتى يدفعوا إلينا شيئًا هو ضرورتنا، ولابد لنا من أَخْذِه، فقال له قارون: وكيف يجب أن نفعلَه؟ فقال له: أن ندخل في الأسبوع يومًا السوق، ونكتسب، وننفق ذلك القَدْرَ في الأسبوع، فأجابه إليه. فكانا يحضران السوق في الأسبوع يومًا، ثم قال له: لستُ أنا وأنت في شيء، فقال: وما الذي يجب أن نعمله؟ فقال له: نكتسب في الأسبوع يومًا لأنفسنا، ويومًا نكتسب ونتصدَّق به، فأجابه إليه. ثم قال له يومًا آخر: لسنا في شيء، فقال: وما ذاك؟ قال: إِنْ مرضنا أو وقع لنا شغل لا نملك قوتَ يومٍ، فقال: وما نفعل؟ قال: نكتسب في الأسبوع ثلاثة أيام؛ يومًا للنفقة ويومًا للصدقة ويومًا للإدخار، فأجابه إليه. فلمَّا عَلِمَ أن حُبَّ الدنيا استمكن من قلبه وَدَّعَه، وقال: إِنِّي مُفارِقُكَ فَدُمْ على ما أنت عليه، فصار من أمره ومالِه ما صار، وحَمَلَه حُبُّ الدنيا على جَمْعِها، وَحَمَلَه جَمْعُها على حُبِّها، وحَمَلَه حُبِّها على البغي عليهم، وصارت كثرةُ مالِه سَبَبَ هلاكِه، وكم وُعِظَ بِتَرْكِ الفَرَجِ بوجود الدنيا، وبِتَرْكِ الاستمتاع بها! وكان لا يأبى إِلاَّ ضلالًا. ويقال خَسَفَ اللَّهُ به الأرضَ بدعاِء موسى عليه السلام، فقد كان موسى يقول: يا أرضُ خُذِيه. وبينما كانت الأرض تُخْسَفُ به كان يستعين بموسى بحقِّ القرابة، ولكن موسى كان يقول: يا أرضُ خُذِيه. وفيما أوحى اللَّهُ إلى موسى: لقد ناداك بحقِّ القرابة وأنت تقول: يا أرض خذيه! وأنا أقول: يا عبدُ، نادِني فأنا أقرب منه إليك، ولكنه لم يَقُلْ.وفي القصة أنه كان يُخْسَفُ به كل يوم بزيادة معلومة، فلمَّا حَبَسَ اللَّهُ يونسَ في بطن الحوتِ أَمَرَ الحوتَ أن يطوفَ به في البحار لئلا يضيقَ قلبُ يونس، حتى انتهى إلى قارون، فسأله قارونُ عن موسى وحاله، فأوحى الله إلى المَلَك: لا تَزِدْ في خَسْفِه لحرمة أنه سأل عن ابن عمه، ووَصَلَ بَه رَحِمَه.
{وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77)}.وَعْظُ مَنْ حُرِمَ القبولَ كمثل البَذْرِ في الأرض السَّبِخَة؛ ولذا لم ينفَعْه نُصْحُهم إياه، ولم يكن للقبول في مساغٌ.
{وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} ليس النصيبُ من الدنيا جَمْعَها ولا مَنْعَها، إنما النصيبُ منها ما تكون فيه فائدة بحيث لا يُعْقِبُ ندمًا، ولا يُوجِبُ في الآخرةِ عقوبةً. ويقال النصيبُ من الدنيا ما يَحْمِلُ على طاعته بالنَّفْس، وعلى معرفته بالقلب، وعلى ذِكْرِه باللسان، وعلى مشاهدته بالسِّرِّ.
{وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ} إنما كان يكون منه حسنة لو آمن بالله؛ لأنَّ الكافرَ لا حَسَنَة له. والآية تدل على أن لله على الكافر نِعَمًا دنيوية. والإحسانُ الذي أُمِرَ به إنفاقُ النعمةِ في وجوهِ الطاعةِ والخدمة، ومقابلتُه بالشكران لا بالكفران. ويقال الإحسانُ رؤيةُ الفضلِ دون تَوَهُّم الاستحقاق.قوله جلّ ذكره:
{قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِى} ما لاحَظَ أحدٌ نَفْسَه إلا هَلَكَ بإعجابه. ويقال السُّمُّ القاتلُ، والذي يطفئ السراجَ المضيءَ النظرُ إلى النَّفْسِ بعين الإثباتِ، وتَوَهُّمُ أَنَّ منك شيئًا من النفي أو الإثبات. اهـ.
 .تفسير الآيات (79- 83):
.تفسير الآيات (79- 83):
قوله تعالى:
{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (81) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (82) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83)}.
 .من أقوال المفسرين:
.من أقوال المفسرين:
 .قال البقاعي:
.قال البقاعي:
{فخرج على قومه} أي الذين نصحوه في الإقتصاد في شأنه، والإكثار في الجود على إخوانه، ثم ذكر حاله معظمًا لها بقوله:
{في زينته} أي التي تناسب ما ذكرنا من أمواله، وتعاظمه في كماله من أفعاله وأقوله.ولما كان كأنه قيل: ما قال قومه؟ قيل:
{قال الذين يريدون} أي هم بحيث يتجدد منهم أن يريدوا
{الحياة الدنيا} منهم لسفول الهمم وقصور النظر على الفاني، لكونهم أهل جهل وإن كان قولهم من باب الغبطة لا من الحسد الذي هو تمني زوال نعمة المحسود:
{يا ليت لنا} أي نتمنى تمنيًا عظيمًا أن نؤت من أيّ مؤت كان وعلى أيّ وجه كان
{مثل ما أوتي قارون} من هذه الزينة وما تسببت عنه من العلم، حتى لا نزال أصحاب أموال، ثم عظموها بقولهم مؤكدين لعلمهم أن من يريد الآخرة ينكر عليهم:
{إنه لذو حظ} أي نصيب وبخت في الدنيا
{عظيم} بما أوتيه من العلم الذي كان سببًا له إلى جميع هذا المال، ودل على جهلهم وفضل العلم الرباني وحقارة ما أوتي قارون من المال والعلم الظاهر الذي أدى إليه باتباعه قوله:
{وقال الذين} وعظم الرغبة في العلم بالبناء للمفعول إشارة إلى أنه نافع بكل اعتبار وباعتبار الزهد، وبالتعبير عن أهل الزهد به فقال:
{أوتوا العلم} أي من قومه، فشرفت أنفسُهم عن إرادة الدنيا علمًا بفنائها، زجرًا لمن تمنى مثل حاله، وشمرًا إلى الآخرة لبقائها:
{ويلكم} أي عجبًا لكم، أو حل بكم الشر حلولًا، وأصل ويل، وي قال الفراء: جيء بلام الجر بعدها مفتوحة ما المضمر نحو وي لك، ووي له، أي عجبًا لك وله، ثم خلط اللام بوي لكثرة الاستعمال حتى صارت كلام الكلمة فصار معربًا بإتمامه ثلاثيًا، فجاز أن يدخل بعدها لام أخرى في نحو ويلًا لك، لصيرورة الأول لام الكلمة، ثم نقل إلى باب المبتدأ فقيل: ويل لك، وهو باق على ما كان عليه في حال النصب إذ الأصل في ويل لك: هلكت ويلًا، أي هلاكًا فرفعوه بعد حذف الفعل نفضًا لغبار الحدوث، وقيل: أصل ويل الدعاء بالهلاك، ثم استعمل في الزجر والردع والبعث على ترك ما لا يرتضى كما استعمل لا أبا لك- وأصله الدعاء على الرجل- في الحث على الفعل، فكأنهم قالوا: ما لنا يحل بنا الويل؟ فأخبروهم بما ينبغي معرضين عما استحقوا به الويل من التمني، تحقيرًا لما استفزهم حتى قالوه فقالوا:
{ثواب الله} أي الجليل العظيم
{خير} أي من هذا الحطام، ومن فاته الخير حل به الويل؛ ثم بينوا مستحقه تعظيمًا له وترغيبًا للسامع في حاله فقالوا:
{لمن آمن وعمل} أي تصديقًا لإيمانه
{صالحًا} ثم بين سبحانه عظمة هذه النصيحة وعلو قدرها بقوله مؤكدًا لأن أهل الدنيا ينكرون كونهم غير صابرين:
{ولا يلقاها} أي لا يجعل لاقيًا لهذا الكلمات أوالنصيحة التي قالها أهل العلم، أي عاملًا بها
{إلا الصابرون} أي على قضاء ربهم في السراء والضراء، والحاملون أنفسهم على الطاعات الذين صار الصبر لهم خلقًا، وعبر بالجمع ترغيبًا في التعاون إشارة إلى أن الدين لصعوبته لا يستقل به الواحد.ولما تسبب عن نظره هذا الذي أوصله إلى الكفر بربه أخذه بالعذاب، أشار إلى ذلك سبحانه بقوله:
{فخسفنا} أي بما لنا من العظمة
{به وبداره} أي وهي على مقدار ما ذكرنا من عظمته بأمواله وزينته، فهي أمر عظيم، تجمع خلقًا كثيرًا وأثاثًا عظيمًا، لئلا يقول قائل: إن الخسف به كان للرغبة في أخذ أمواله
{الأرض} وهو من قوم موسى عليه الصلاة والسلام وقريب منه جدًا- على ما نقله أهل الأخبار- فإياكم يا أمة هذا النبي أن تردوا ما آتاكم من الرحمة برسالته فتهلكوا وإن كنتم أقرب الناس إليه فإن الأنبياء كما أنهم لا يوجدون الهدى في قلوب العدى، فكذلك لا يمنعونهم من الردى ولا يشفعون لهم أبدًا، إذا تحققوا أنهم من أهل الشقا
{فما} أي فتسبب عن ذلك أنه ما
{كان له} أي لقارون، وأكد النفي- لما استقر في الأذهان أن الأكابر منصورون- بزيادة الجار في قوله:
{من فئة} أي طائفة من الناس يكرون عليه بعد أن هالهم ما دهمه، وأصل الفئة الجماعة من الطير- كأنها سميت بذلك لكثرة رجوعها وسرعته إلى المكان الذي ذهبت منه
{ينصرونه}.ولما كان الله تعالى أعلى من كل شيء قال:
{من دون الله} أي الحائز لصفات الكمال، المتردي بالعظمة والجلال، لأن من كان على مثل رأيه هلك، ومن كان من أولياء الله راقب الله في أمره، فلم يسألوا الله فيه، وعلم هو أن الحق لله، وضل عنه- كما في الآية التي قبلها- ما كان يفتري
{وما كان} أي هو
{من المنتصرين} لأنفسهم بقوتهم.